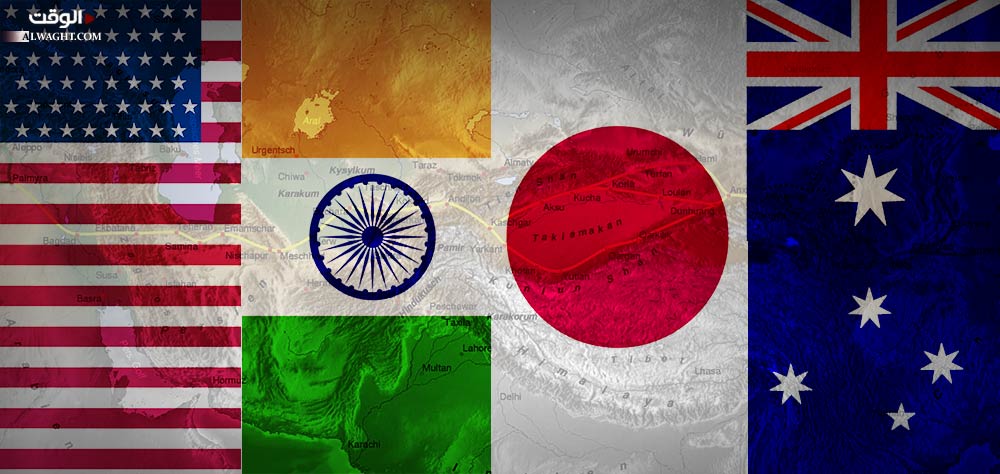الوقت- في إطار محاولاتها الرامية لمواجهة طريق الحرير الصيني، الذي وصل إلى دول كثيرة في آسيا وأوروبا وإفريقيا، اتخذت أمريكا إجراءات متعددة لإنشاء تكتل عالمي جديد للسيطرة على الطرق والمنافذ الدولية، في حين يبدو أن معالم الصراع على الهيمنة الاقتصادية والتجارية الدولية بدأت تتعاظم وتتسع رقعتها في الوقت الحاضر.
ولم تعد المواجهة بين واشنطن وبكين تقتصر على الضغوط والقيود المتبادلة على سلع كل منهما، ولاسيّما بعد تولي "دونالد ترامب" رئاسة أمريكا، مطلع عام 2017، وإنما خرجت إلى نطاقات دولية، وسط مساع أمريكية إلى هدم جسور الصين التجارية وليس منافستها.
وتناقش أمريكا وأستراليا والهند واليايان مشروع بنية تحتية دولية مشتركاً كبديل لمبادرة الحزام والطريق الصينية (طريق الحرير) سعياً لمواجهة اتساع نطاق نفوذ بكين.
وباتت مبادرة حزام طريق الحرير، التي أطلقتها الصين عام 2013، تحظى بانضمام عشرات الدول، حتى غدت دول أوروبية كبرى تسعى وراء الاستفادة منها، بينما كانت من أكثر حلفاء أمريكا اقتصادياً في السنوات الماضية.
ويعد طريق الحرير أضخم مشروع اقتصادي تطلقه الصين، ويشمل مشاريع للسكك الحديدية والطرق السريعة والمرافئ والطاقة تتجاوز قيمتها 1.2 تريليون دولار، ويغطي مناطق الصين وغرب آسيا وأوروبا، وانضم إليه حتى الآن نحو 65 بلداً.
ويهدف الطريق إلى إنشاء مسارات تجارية متفق عليها بين عدد كبير من الدول، وبمبادرة اقتصادية واحدة، بحيث يتم تبادل المشاريع والصفقات والأدوات التجارية والمالية وصولاً إلى عولمة جديدة، تعتبر الصين أنها ستكون لمصلحة الشعوب.
ومن المفترض أن يربط طريق الحرير الجديد الصين بكازاخستان وروسيا على امتداد أكثر من 10 آلاف كيلومترات.
وسيغير طريق الحرير حجم التجارة الصينية إلى 3 تريليونات دولار ويضعها على رأس أكبر اقتصاد عالمي. وهنالك العديد من الفوائد التي ستصب في مصلحة الصين أهمها تصدير الفائض من الإنتاج بوقت أسرع من قبل وفتح أسواق جديدة للسلع.
وبجانب التمدد الصيني في آسيا وإفريقيا خلال العقدين الماضيين، بدا واضحا خلال السنوات الأخيرة أن قطار نفوذها بدأ يصل إلى أوروبا التي وصلت سلعها إليها عبر قطارات شحن متعددة الوجهات.
وخلال أقل من عشرين عاماً، باتت الصين أول شريك اقتصادي مع إفريقيا، ووصلت المبادلات التجارية بين الطرفين إلى 190 مليار دولار عام 2016،
وتشتمل المبادرة الصينية على عدّة مشاريع كبرى، ففي باكستان تقود بكين عملية تحويل ميناء جوادر في جنوب البلاد إلى مركز للطاقة يربط الصين بالشرق الأوسط. ويتضمن هذا المشروع بناء طريق وشبكة أنابيب تمتد من ميناء جوادر إلى غرب الصين، وهو ما يقلص رحلة استيراد مواد الطاقة من 12 ألف كيلومتر عبر البحر إلى 3 آلاف كيلومترات.
كما تم إقامة ربط بين إيران والصين عبر السكك الحديدية في 2016، بالإضافة إلى بوابة خورجوس، وهي مركز رئيس لشحن البضائع ما بين الصين وكازاخستان يتم العمل فيه حالياً، ومن المتوقع أن يتم تمديده في إطار مبادرة الحزام الاقتصادي.
وهناك مشاريع واعدة أخرى في غاية الأهمية لم يبدأ العمل بها بعد، ومن بينها مشروع الربط عبر السكك الحديدية بين بكين وموسكو (7 آلاف كيلومترات)، وجنوب الصين وماليزيا وسنغافورة (3 آلاف كيلومترات)، علاوة على ميناء في المياه العميقة في سريلانكا.
ولتمويل المبادرة، أعلنت الصين في القمة الخاصة بطريق الحرير في مايو/ أيار 2017، أنها ستنفق 124 مليار دولار على المشاريع، في حين أنها قدمت في السابق القروض بقيمة 890 مليار دولار من خلال بنوك التنمية والبنوك متعددة الأطراف الصينية.
ويبدو ان ثمة اسبابا وراء إقدام الصين على هذا المشروع الطموح والمكلف.
ويرجع السبب الأول، إلى أن تباطؤ النمو في الاقتصاد الصيني، قد أدى إلى فائض في الطاقة الإنتاجية، خصوصاً في المشاريع الكبيرة لتنمية البنية التحتية والتي اكتسبت فيها الشركات الصينية خبرة جيدة، وبإمكان المبادرة أن تفسح مجالاً لتصدير هذه الطاقة الإنتاجية والمهارات التكنولوجية التي من شأنها أن تشكل عامل دفع للاقتصاد المحلي.
وثانياً: ما يزال هناك فائض كبير في المدخرات المحلية بالصين، لذا فإن صنّاع القرار يرون أن الاستثمار الخارجي في المشاريع التي تشرف عليها وتقودها بكين هو وسيلة مهمة لتوجيه تلك المدخرات إليها.
ومن المفترض أن تجني الصين فوائد من زيادة حجم التدفقات التجارية، فمن بين جميع الأطراف المشاركة في مبادرة حزام طريق الحرير، يرجح أن يستفيد المصدرون الصينيون والقطاعات الصينية المرتبطة بالتجارة أكثر من غيرهم، فالمبادرة ستخفض تكاليف النقل وتقلل أوقات التسليم وتحسن إمكانية الوصول للأسواق النامية والناشئة.
وتطمح الصين لرفع حجم التجارة بينها وبين دول الحزام إلى نحو 10 تريليونات دولار خلال خمس سنوات. وفي مقابل التمدد الصيني، باتت أمريكا تشعر بقلق متزايد من إمكانية تعرضها للعزلة، ولاسيّما مع تبني ترامب سياسات غير منطقية أغضبت الشركاء التجاريين لأمريكا، خاصة الدول الكبرى في أوروبا وعلى رأسها ألمانيا، بالإضافة إلى كندا والمكسيك.
وربما يكون العالم على وشك الدخول في "حرب باردة جديدة"، هذه المرة ستدور رحاها بين واشنطن وبكين، وليس بين واشنطن وموسكو، كما كان الحال طوال العقود الأربعة التي تلت الحرب العالمية الثانية، وانتهت بسقوط وتفكك الاتحاد السوفييتي في مطلع تسعينات القرن الماضي.