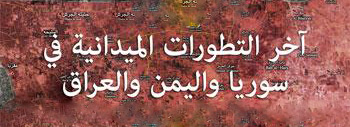الوقت- يشهد جيش الاحتلال الإسرائيلي واحدة من أكبر أزمات القوى البشرية في تاريخه الحديث، إذ قدّر مسؤولون عسكريون أن هناك نقصًا يتراوح بين 10 و12 ألف جندي، منهم ما بين 6 و7 آلاف مقاتل في الوحدات القتالية الأساسية، وهو نقص شكّل ضغطًا غير مسبوق على منظومة التعبئة العسكرية في ظل استمرار الحرب على غزة واتساع العمليات الميدانية. ومع تفاقم الحاجة، تتصاعد حالة الرفض داخل شرائح واسعة من المجتمع، أبرزها مجتمع الحريديم الرافض تقليديًا للتجنيد، إلى جانب فتور متزايد بين جنود الاحتياط الذين أبدى بعضهم ترددًا أو رفضًا للعودة إلى الخدمة، ما جعل الأزمة تتخذ طابعًا اجتماعيًا وسياسيًا يتجاوز البُعد العسكري التقليدي ليعكس أزمة ثقة داخلية عميقة.
عجز متزايد في صفوف الجيش رغم توسع الاستدعاءات
تفاقم نقص المقاتلين دفع الجيش إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، من بينها تمديد خدمة الجنود النظاميين بعد انتهاء فترات خدمتهم الرسمية، إضافة إلى إطلاق أوامر استدعاء لآلاف من جنود الاحتياط في محاولة لتغطية الثغرات المتزايدة. إلا أنّ هذا المسار واجه عقبات كبيرة، إذ أشارت تقارير إلى انخفاض مستويات الاستجابة بين الاحتياط، ناتجة عن الإنهاك المتكرر، ورفض البعض العودة إلى خطوط المواجهة لأسباب تتعلق بالإحباط أو المعارضة السياسية لنهج القيادة العسكرية.
وفي ظل هذا العجز، لجأت القيادة إلى تجارب جديدة، من بينها فتح باب التجنيد أمام يهود الجاليات في الخارج لتعويض الفجوات، في خطوة عدّها محللون إشارة واضحة على عمق الأزمة التي يعاني منها الجيش في استقطاب قوى بشرية محلية كافية. ومع ذلك، يبقى الاعتماد على الخارج حلاً محدود الفاعلية، ويثير أسئلة إضافية حول قدرة الجيش على الحفاظ على حد أدنى من التجانس الداخلي في صفوفه.
الحريديم بين الرفض الشعبي والضغط الحكومي
القضية الأكثر حساسية في ملف التجنيد هي ملف الحريديم، إذ يشكّل هؤلاء إحدى أكثر الفئات رافضة للخدمة العسكرية. وبرغم إصدار نحو 54 ألف أمر استدعاء لطلاب المعاهد الدينية عقب قرار قضائي بإلغاء الإعفاءات، تشير مصادر عديدة إلى أن نسبة التجنيد الفعلية لا تتجاوز 5%، وهو ما يعكس فجوة كبيرة بين القرارات الحكومية والواقع الاجتماعي. الاحتجاجات التي نظّمها الحريديم في شوارع القدس وتل أبيب أظهرت بوضوح أن هذه الفئة مستعدة لمواجهة سياسات التجنيد بالقوة المدنية، وهو ما يضع الحكومة أمام مأزق حقيقي: فهي من جهة تحتاج إلى الجنود، ومن جهة أخرى تدرك حساسية الدخول في صدام مباشر مع كتلة انتخابية ودينية ذات وزن كبير.
رفض الحريديم لا يستند فقط إلى اعتبارات دينية وتعليمية، بل يمتد إلى موقف اجتماعي يرى أن الحرب الحالية لا تبرر التخلي عن النهج التقليدي الذي حظي هؤلاء بموجبه بإعفاءات تاريخية. ومن هنا، فإن أي محاولة لفرض التجنيد بالقوة قد تؤدي إلى تصاعد التوترات الداخلية، وربما تضع الحكومة في مواجهة سياسية مفتوحة مع الأحزاب الدينية.
احتياطيون مترددون وانخفاض لافت في الروح المعنوية
إلى جانب أزمة الحريديم، تشكل أزمة الاحتياط عامل ضغط لا يقل أهمية. فالجيش يعتمد تاريخيًا على قوات الاحتياط كركيزة أساسية في نظريته القتالية، لكن مؤشرات السنوات الأخيرة تكشف عن تراجع واضح في مستويات الالتزام. فبعض التقارير أفادت بأن الاحتياطيين باتوا أقل حماسًا للعودة إلى الخدمة، وأن بعضهم تحدّث عن إنهاك مستمر، بينما برّر آخرون امتناعهم بمواقف أخلاقية وسياسية تتعلق بطبيعة العمليات الجارية أو بإدارة الحرب من قبل القيادة العسكرية والسياسية.
هذا التراجع في جاهزية الاحتياط يفرض مشكلة مزدوجة: فمن ناحية يضعف قدرة الجيش على تنفيذ عمليات موسعة تتطلب أعدادًا كبيرة من القوات المدربة، ومن ناحية أخرى يعمّق الفجوة بين القيادة والجنود، وهو ما يؤدي إلى تراجع الروح المعنوية والقدرة على الحفاظ على تأهب مستدام.
تكاليف اقتصادية واجتماعية تتراكم مع طول أمد الحرب
لا يتوقف تأثير الأزمة عند حدود الجيش، بل يمتد ليشمل الاقتصاد والمجتمع. فاستدعاء الاحتياط لفترات طويلة أدى إلى خسائر تُقدّر بمليارات الشواكل نتيجة غياب عشرات الآلاف من العمال عن مواقع عملهم. وهذا بدوره يساهم في خلق حالة من التململ لدى قطاعات اقتصادية واسعة، ترى أن الحرب أصبحت عبئًا يهدد استقرارها، خصوصًا أن جزءًا كبيرًا من العمال المستدعين ينتمون إلى قطاعات حيوية.
كما أدت الضغوط النفسية الناتجة عن طول أمد الخدمة والتكرار المستمر للاستدعاءات إلى زيادة الاحتقان داخل الأسر، ما جعل بعض المحللين يتحدثون عن أزمة اجتماعية موازية للأزمة العسكرية، تتجلى في ارتفاع معدلات الإرهاق النفسي والعائلي بين الجنود وأسرهم.
في النهاية، يمكن القول إن أزمة نقص المقاتلين في جيش الاحتلال ليست مجرد أزمة ظرفية ناجمة عن حرب طويلة، بل هي أزمة بنيوية تعكس عمق الانقسام داخل المجتمع، وتكشف حدود قدرة الدولة على تجنيد مواطنيها في وقت الحاجة.